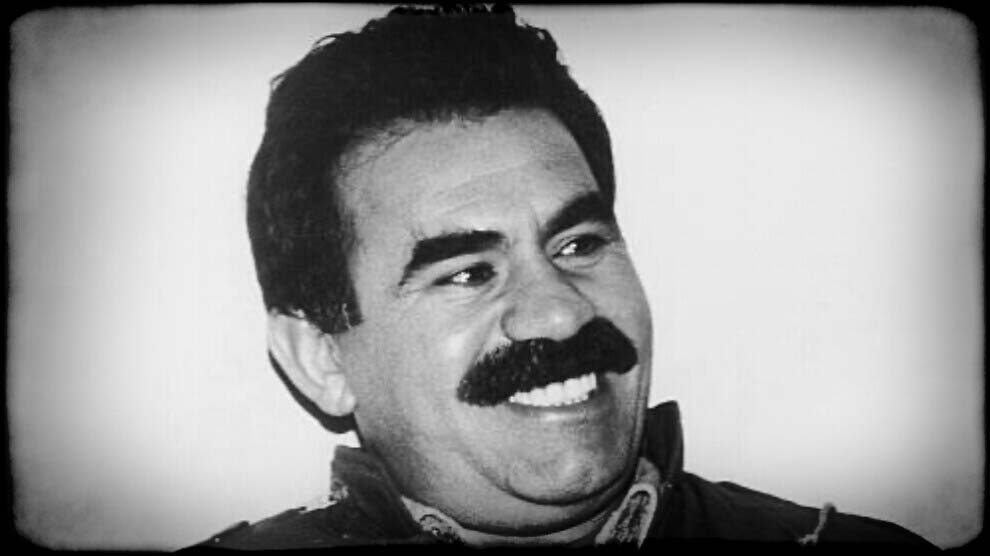الدولةُ القومية بوصفها المتقطعة الثالثة والأهم على الإطلاق للحداثة، هي الصياغةُ الأداتيةُ الأولية بتاتاً لممارسةِ الرأسمالية في غزوِ المجتمعِ واستعماره.
فبينما تَعرضُ الليبراليةُ نفسَها على أنها تكامُلَ الأهداف (مجتمع المُثُل)، فالدولةُ القوميةُ تَجِدُ معناها باعتبارها الصياغةَ الأساسيةَ للسلطة. إذ أن تطبيق الغزو والاستعمار داخلياً وخارجياً، والأشمل نطاقاً مما واجَهَه المجتمع في سياقِه التاريخي؛ أمرٌ مستحيلٌ دون وجودِ شكلِ الدولة القومية.
الموضوعُ الذي مارسَت عليه علومُ الاجتماع التعميةَ والتحريفَ، وأَضفَت عليه القوالب الدوغمائية أكثر من غيره، هو الدولة القومية مرةً أخرى. إذ لا يزال من العسير القول بأنها طَرحَت تحليلاتٍ شاملةً بشأن الدولة. حتى إن ماركسياً مثل لينين عجز عن إنقاذِ تحليلاته بصدد "قضية الدولة والسلطة" من ركيزتها المتمثلة في الدولة القومية، لدى تَوَجُّهِه صوب إحدى أعظم الثورات الاجتماعية في التاريخ. بل دَعكَ من النجاح جانباً، إنما لم يتمالك نفسَه من تقييمِ تحويلِ السوفييات، التي هي تنظيم المجتمع الديمقراطي، إلى دولةٍ قومية على أنه ترسيخٌ للثورة؛ بالرغم من كل انتقاداته. والدولةُ القوميةُ الصينيةُ اليوم خيرُ مثالٍ عملاقٍ بارزٍ للبرهان على الموقف عينه من خلال خدماتها الأكبر للرأسمالية العالمية.
فيما يتعلق بتعاطي أنطوني غيدنز لأَحَدِيَّةِ الدولة القومية، وبالرغم من اتسامه بنسبةٍ من الواقعية، إلا أنه سردٌ ناقصٌ للغاية من حيث عقد روابطها المتسلسلة مع احتكارات السلطة التراكمية التاريخية. لن أُكَرِّرَ هنا تعريفَ الدولة القومية، كوني سعيتُ لتعريفها بإسهابٍ شامل في المجلَّدَين السابقَين. بل سأعمل على تعزيز السرد ودعمه بتسليط الضوء على الموضوع من مناحي مختلفة، والإشارة إلى النتائج الواجب استخلاصها.
يجب قبلَ كل شيء التفكيرَ بالدولة القومية (دولة الأمة) على أنها الشكلُ الأعظمي للسلطة. ذلك أنه ما مِن شكلٍ للدولة يشتمل على السلطة بقدرِ ما هي الدولة القومية (قد يَكُون من الأصح القول بأمة الدولة). السبب الأولي لذلك يكمن في ارتباط الشريحة العليا من الطبقة الوسطى بسياقِ التحول الاحتكاري بنحوٍ متزايد. ينبغي ألا يَغيب عن البالِ بتاتاً أن الدولة القومية بذاتها الاحتكار الشامل الأرقى. فالاحتكار التجاري والصناعي والمالي يُوَطِّدُ أقصى درجات التحالف مع احتكار السلطة في مرحلة الدولة القومية. إنها الاتحاد الأكثر تَقَدُّماً لإجماليِّ الاحتكارات. هذا ومن المهم التفكير بالاحتكار الأيديولوجي أيضاً على أنه جزءٌ لا يتجزأ من احتكار السلطة ضمن هذا المضمار.
أحدُ أكثرِ الميادين التي مارست علومُ الاجتماعِ حركةَ التشويش والتضليل بصددها هي تلك المعنية بالاحتكارات. إذ تُبدِي عنايةً فائقةً من أجل مَوضَعَةِ أجهزةِ السلطة – بوصفها عابرةً للاقتصاد – بشكلٍ منفصلٍ عن الاحتكارات التجارية والصناعية والمالية. هكذا تَرغَب في عرض السلطةِ عموماً والدولةِ خصوصاً وكأنهما ظاهرتان مختلفتان عن ظاهرة الاحتكار. هذه هي إحدى النقاط الأساسية التي تُبقي على علوم الاجتماع قاصرةً معلولة. إذ لا يمكن إيضاح الفرق بين الاحتكارات عابرة الاقتصاد واحتكارات السلطة، إلا من جهةِ تقسيم العمل بينها. وفيما عدا ذلك، فالتكامل الذي بينها تاريخي وحاسم. إني مضطرٌّ لذِكرِ جملةٍ وجدتُها مؤثرةً جداً لفرناند بروديل. حيث يقول بروديل: "السلطةُ أيضاً تُكَدَّسُ كما رأس المال". وكأنه أَمسَكَ بخيطِ التكامل الذي بينهما. علماً أنه شخصٌ حكيم يُسَلِّطُ الضوءَ على الموضوع من جهاتٍ عدة.
السلطةُ لا تُكَدَّسُ كرأس المال وحسب، بل هي حالُ رأسِ المال المتجانس والمُصَفَّى والمُكَدَّس تاريخياً بأعلى المستويات. وإن كتَبتُها بالخط العريض: السلطةُ هي حالُ رأسِ المال المتجانس والمُصَفَّى والمُكَدَّس تاريخياً بأعلى المستويات. أما رؤوس الأموال الأخرى العابرة للاقتصاد، فيتم تراكُمها بمنوالٍ مختلف، وتنظيمها وتَبَدُّل زمامها. هذا ومن الضروي النظر وإيلاء المعنى لجميعها بوصفها احتكارات تأسيساً على كونها عابرة للاقتصاد، وتتميز بماهيتها في الاستيلاء على القيم الاجتماعية عموماً وعلى فوائض القيم الاجتماعية على وجه الخصوص (الاستيلاء = الاحتكار). ذلك أن كل التسريبات المستاقة من المجتمع ذات نوعية احتكارية، سواءً كانت ضريبةً، أم ربحاً إدارياً، أم نهباً وسلباً علنياً. لذا، ينبغي إدراك مصطلح الاحتكار بشكلٍ حسنٍ وفي محله الصحيح.
تَكمنُ مكانة الدولة القومية ضمن التاريخ في توحيدها لجميعِ تلك الاحتكارات ضمن نطاقها بشكلٍ حسن. هكذا تصبح التكامُلَ الأقصى لرأس المال، وتنتهل قوتها من وضعها هذا. وكونها الأداة الأكثر تأثيراً في تراكم رأس المال، إنما يتأتى من وضعها هذا. إن ظَهورَ الحزب البلشفي للعيان على شكلِ تكامُلٍ ضخمِ الجثة لرأس المال بعد مرور سبعين سنة على تشييد الدولة القومية، كان قد أذهَلَنا جميعاً. مع أن هذا الوضع مفهومٌ لآخرِ درجة، في حالِ نظرنا إلى الموضوع من زاويةِ تحليلِ الدولة القومية. ذلك أن تنظيم الدولة القومية هي الحالة النموذجية لتنظيم رأس المال على شكلِ دولة، بل ومن أقصر الطرق أيضاً. وعن طريق الدولة القومية يمكن تنظيم الرأسمالية الأكثر خصوصية، لا الاشتراكية. فكيفما يَكُونُ تصييرُ البغلِ فرساً أمراً ممكناً، كذا فتصييرُ أو اعتبارُ الدولة القومية اشتراكيةً أمرٌ ممكن بالمثل.
رغم ذلك، لا يمكن إيضاح أَحَدِيَّةِ الدولة القومية بِفصلِها عن الأشكال التاريخية. فمهما ارتقت بدرجةِ تبايُنها واختلافها، إلا أن المُعَيِّن هو التراكم التاريخي للسلطة. لِنَنظُرْ إلى إنكلترا بوصفها أولَ بلدٍ نَظَّمَ الدولةَ القومية: فإنكلترا كانت مُحاصَرَةً بسلطاتِ إسبانيا وفرنسا والنورميين في مطلع القرن السادس عشر. خطر الزوال واضحٌ هنا، في حال لم تُنَظِّمْ نفسَها كدولةٍ قومية. ذلك أنها كانت مَلَكية، تتعاقَب السلالات الحاكمة عليها بالتوالي. واقتصادُها مبنيٌّ على الهجرات الوافدة عن طريق أوروبا منذ العهد النيوليتي. أما فارِقُها الذي يُمَيِّزُها عن الأوروبيين الآخَرين، فهو أساساً وضعُها كجزيرة. وهي تُشَيِّدُ دولتَها القوميةَ استناداً إلى هذه الظروف التاريخية الملموسة. التاريخُ يَنُصُّ بكلِّ شفافية على كيفيةِ جريانِ تلك المرحلة من خلالِ زيادةِ قوةِ سترلين ، وتكاتُفِها مع تَحَوُّلِها الاحتكاري الأقصى عبر الاستدانة والاقتصاد. هذا ومن المعلوم انكبابها على الثورة الصناعية أيضاً في سبيل انطلاقةٍ مهيمنة. هذا ما مفاده أنه فيما يتعلق بالتاريخ الإنكليزي، وبالأخص بتاريخ السلالات فيه؛ دعك جانباً من قيامِ الدولة القومية الإنكليزية، بل من المحال التفكير بها بتاتاً، دون وجودِ السلالات على وجهِ الخصوص. فالسلالةُ هي شكلُ الدولة الأشمل نطاقاً والأطول أَمَداً على مر التاريخ. وعدمُ تَخَلِّي إنكلترا عن التباهي بالسلالاتية إلى الآن، إنما على صلةٍ وثيقةٍ بهذا الجانب من التاريخ. بينما الديمقراطياتُ والجمهورياتُ ضيقةُ النطاق جداً. والإمبراطوريات شكلٌ مختلف. من هنا، يستحيل تشكيل الدول عموماً والدول القومية على وجه الخصوص، دون وجودِ تراكمات السلطة، باعتبارها تتأتى على مر آلاف السنين بالتسرب كاحتكارٍ هو الأنقى والأصفى.
نادراً ما تم التطرق إلى أواصرِ الدولة القومية مع المصادر الثيولوجية. لكن هذا الموضوع هامٌّ لأبعدِ حد. لقد أنارَ كارل شميث الحقيقةَ بأحدِ جوانبها، عندما أشار إلى أن جميع المصطلحات السياسية المعاصرة تنبع من المصادر الثيولوجية (علم الإلهيات). فبِتَعَمُّقِه السوسيولوجي الدقيق، لا يُلاقي صعوبةً في تشخيصِ الدين وتَصَوُّرِ الإله ارتباطاً به بأنهما الشكل الأقدم للهوية الاجتماعية. ينبغي استيعابَ الدين ووعي الإله على أنهما ضرورةٌ لعصورِ الذهنياتِ، بدلاً من اعتبارِ كلٍّ منهما هويةً تَصَوُّرِية مقصودةً عن وعي. إنه يَعتَقِدُ بأنَّ تصييرَ التصورِ الاجتماعي الجماعي لنفسِه هويةً من خلال أقدس المصطلحات، هو أحد الطرق الهادفة للبقاء رصيناً. وفي جذورِ الألوهية يَكمُنُ تقدس الوجود الاجتماعي. وكلما تسارَعَ الانفصالُ بين السلطة والدولة والمجتمع مع مرورِ الزمن، كلما خَرَجت حصَّتا القدسية والألوهية من كونهما الهويةَ الجماعية للمجتمعِ برمته، لِتَغدُوَا حِكراً على أصحاب السلطة والدولة. والهيمنةُ الأيديولوجيةُ تلعب دوراً هاماً هنا. إذ يتم التنويه إلى أن السلطةَ والدولةَ نابعتان من الرب، بالتالي، تَكُونُ بذلك قد فتحت السُّبُلَ أمام المزاعمِ القائلة بأن أصحابَ السلطة والدولة بِحَدِّ ذاتهم أيضاً مقدَّسون وإلهيون. بات ليس من العسير بلوغ مصطلحَي المَلِك – الإله ودولة الرب. هذا ولن يتأخر اصطلاحا رسول الرب وظل الإله عن النماء على التوالي.
وبالرغم من مساعي مصطلح الدولة العلمانية في الإبقاء على ذاته خارج هذا السياق، إلا أن ذلك غير صحيح. فالعلمانيةُ التي هي المبدأ الأولي للجماعةِ الماسونية المستاءةِ من تأثير الكنيسة، والتي تطغى عليها الأصول اليهودية؛ إنما تنتهل وجودَها من هذا المصطلح بنسبةٍ ساحقة بِحُكمِ طبيعتها وبوصفها القطبَ المقابل لمبدأ الروحانية. ينبغي التبيان علانيةً أنه لا العلمانيةُ دُنيَوِيّةٌ بقدرِ ما يُعتَقَد، ولا الروحانيةُ أُخرَوِيّةٌ بقدرِ ما يُعتَقَد. فكِلا المصطلحَين دُنيَوِيّان واجتماعيان. بينما القوالبُ الأيديولوجيةُ قد فَتَحَت هُوَّةَ الفرق بينهما.
بناءً عليه، من المُتَوَقَّع انعكاس التَصَوُّرِ ذي الأصول الإلهية للسلطة والدولة على عصرنا الراهن كما هو عليه طيلة العصورِ بأكملها. هذا ومن غير الممكن عدم التفكير بتَأثُّرِ الدولة العصرية من هذا الانعكاس. فقد عُجِنَ المصطلحُ بهذا المنوال على مر التاريخ. من هنا، فالدولة العلمانية أو مصطلح السلطة متناقضٌ وغامض.
الدولةُ القوميةُ مشحونةٌ بالمصطلحات الإلهية أكثر مما يُعتَقَد، وتابعةٌ لمراسيم التقديس بما لا يُشاهَد في أيةِ مرحلةٍ تاريخية. فالمصطلحاتُ التي تعتمد عليها وتختارها تَصَوُّراً لها من قبيل "الوطن"، "العَلَم"، "المركزية"، "الاستقلال"، "القدسية"، "المارش- الموسيقا"، و"النصوص القِصَصية"؛ إنما تتميز بنصيبها من الألوهية بما يُضاهي المُلوك – الآلهة. وما مِن دولةٍ تَحَصَّنَت بالدروعِ الأيديولوجية والحقوقية والسياسية والاقتصادية والدينية، بقدرِ ما هي عليه الدولةُ القومية. مُؤَكَّدٌ أن الدافع الأولي لذلك يكمن في بوابةِ العبور الرئيسية نحو بيروقراطيةٍ مدنيةٍ – عسكرية متضخمة للغاية. فليُسحَب بساطُ مناصبِ الدولةِ من تحتِ البيروقراطية، فستتحول آنئذٍ إلى سمكةٍ انقطعَ عنها الماء. أي أن الدولةَ بالنسبة لهم مسألةُ حياةٍ أو موت. والتحافُ الدولةِ بأقصى درجات الإفراط في الألوهية على صِلَةٍ كثيبةٍ بخاصيةِ البيروقراطية تلك. كما أن الدافعَ وراء التركيز على الدولة وإقامة القيامة من أجلها في الحداثة الرأسمالية بما لا نظير له في أيةِ حداثةٍ أخرى؛ إنما هو – مرةً أخرى – التغير الجاري في بنيتها الطبقية تلك. هذا وثمة أواصرُ وثيقةٌ وكثيبةٌ بين مصطلح وحدةِ الآلهة وبين التشديد على الحداثة والدولة القومية وعلى "العلموية – المركزية" خصيصاً. فكيفما تم القضاء على القبائل والأقوام مع آلهتها، وصهرها ضمن بوتقةِ القبيلةِ أو القوم الحاكم؛ كذا فقد تم صهر آلهتها أيضاً في بوتقةِ إلهِ القبيلةِ أو القوم الحاكم، وبالتالي توحيدها. وإذ ما نظرنا إلى اصطلاحِ وحدة الآلهة ضمن إطارِ هذا الواقع السوسيولوجي، فسنبلغ فحواه بسهولةٍ أكبر. ذلك أنه يتضمن الاستعمار والصهر.
تاريخُ مركزيةِ الدولةِ القومية إلهيٌّ بشكلٍ كثيفٍ للغاية. فبينما أن تجريدَ المجتمع الموجودِ في طبيعتها من السلاح كلياً، ونقلَ احتكار التسلح تماماً إلى الدولة يؤدي إلى المركزية، فما يتحقق مضموناً هنا هو احتكارٌ استغلاليٌّ واستعماريٌّ مذهل. ومُنَظِّرو الهيمنة (يتصدرهم هوبز ومكيافيلي) قد بَسَطوا أهم خدماتهم أمام الاحتكار الرأسمالي بتعريفهم للدولةِ العصرية باسم العلموية. فتركيزُ كلِّ الأسلحة في بنيةٍ أُحاديةٍ منفردةٍ بذاتها في سبيل رفاهِ المجتمع، كان سيَعني تعريةَ المجتمعِ من قوته السياسية، وبالتالي من وجوده الاقتصادي بما لا نظير له في أيةِ مرحلةٍ تاريخية. ونظراً لِكَون الدولة والسلطة سوف تتحركان بوصفهما احتكاراً في نهاية المطاف، فسوف لن تبقى أيةُ قيمةٍ اجتماعيةٍ إلا وستَستَولِيان عليها بقوةِ السلاح. وسوف تُضفِيان الشكلِ الذي تشاءانه على المجتمع، وستُبِيدان ما تشاءان وتُزيلانه من الوسط. بَيْدَ أن ما جرى في التاريخ قد حصل تأسيساً على هذا المنوال. حيث تحققت الإباداتُ التي لا تَخطر بالبال.
وباعتبار الدولة القومية الانبساطَ المشتركَ لكافةِ الاحتكارات، فهي لا تقتصر على بناء ذاتها تأسيساً على نهبِ الثقافة الاجتماعية المادية وغزوِها واستعمارها، بل وتؤدي دوراً مُعَيِّناً في صهرِ الثقافةِ المعنويةِ أيضاً. إذ تَجعل المعاييرَ الثقافيةَ لأثنيةٍ أو جماعةٍ دينيةٍ حاكمةٍ رسميةً بالأغلب تحت اسم الثقافة القومية، ثم تَشُنُّ الحرب ضد جميعِ الكيانات الثقافية المتبقية. وبذريعةِ أنها "تضر بالوحدة القومية" تُهَيِّئُ النهايةَ لجميع اللغات والثقافات الموجودة لجميعِ الأديان والأثنيات والأقوام والأمم التي لا تَبرح محافظةً على وجودها منذ آلاف السنين. وهي تَعمل ذلك إما بالعنف أو بالتحفيزات المادية المُشَوِّقة. هكذا باتت اللغات، الأديان، المذاهب، والقبائل والعشائر الأثنية، والأقوام والأمم ضحيةَ هذه السياسة، أو بالأحرى ضحيةَ هذه الإبادة بما لا ند له في أيةِ مرحلةٍ من مراحل التاريخ. بل إن الإبادات المادية (الإبادات الجسدية) مقابل الإبادات المعنوية ليست حتى بقدرِ حجمِ الأُذُن في الجَمَل. بالتالي، فالقيم اللغوية والثقافية المتسربلة إلى يومنا منذ آلاف السنين مع جماعاتها، غَدَت الضحية بذريعةِ طيشِ "الوحدة القومية"، وكأنها ممارسةٌ مقدسة.
مفهومُ الدولةِ القومية في "الوطن" أكثر إشكاليةً بكثير. فبأيةِ حالٍ كانت، يتم تصوير الحدود الجغرافية الخاضعة لسيادة الدولة، أي لاحتكارها، على أنها "الوطن المقدس". في الحقيقة، لقد صُيِّرَ الوطنُ مُلكيةً مشتركةً لحلفاءِ الاحتكار. والنظامُ الذي شَيَّدوه بالتأسيس على ذلك، أكثر عُمقاً بكثير في استعماريته من استعمار المستوطَنات القديمة. فإنْ كان ثمة بلد مستعمِرٌ واحدٌ فقط قديماً، ففي الدولةِ القومية العصرية ثمة أشكالٌ استعماريةٌ مسلَّطةٌ على "وطنها المقدس"، تَعدادُها يتماشى مع تعداد الاحتكارات فيها. فكيفما جُرِّدَت الشعوب المستعمَرة من أسلحتها، كذا شعبُ "الوطن المقدس" أيضاً قد جُرِّدَ من أسلحته، متروكاً بلا مقاومة تجاه شتى أنواع الاستغلال. حيث أُخضِعَت شتى كياناته الثقافية المادية والمعنوية، وعلى رأسها قواه العاملة، لاستعمارٍ مضاعَف. إذ من غير الممكن بشكلٍ آخَر إشباعَ نَهَمِ احتكاراتِ البيروقراطية المتضخمة كالوَرَم.
أما دبلوماسيةُ الدولة القومية، وهيئة التنسيق مع الدول القومية الأخرى بوصفها احتكاراتٍ خارجية؛ فيتم تأسيسها في سبيل متابعةِ شؤونِ نظامِ الدول القومية العالمي. ذلك أنه من المستحيل الإبقاء على دولةٍ قوميةٍ واحدةٍ صامدةً لأربعٍ وعشرين ساعةً فقط، في حالِ غيابِ اعترافِ الدول القومية الأخرى بها خارجياً. وعلةُ ذلك مخفيةٌ في منطقِ النظام الرأسمالي العالمي. إذ لا يمكن لوجودِ أيةِ دولةٍ قومية أن يستقر، دون رضا القوة المهيمنة. فقِصصُها جميعاً مكتوبةٌ في دفترِ المهيمن. ومن يَشُذُّ عن القاعدة، إما أن يتعرض لعاقبةٍ وخيمةٍ كما صَدَّام، أو يُطاحُ به بعد تَعريضِه للإفلاس بالحصارِ الاقتصادي. هذا ويُفتَرَضُ أن كلَّ دولةٍ قوميةٍ تَعلَمُ علمَ اليقين استحالةَ بقائها راسخةً، دون إِذنِ وسماحِ القوة المهيمنة. فحتى دولتا الاتحادِ السوفييتي والصين عجزتا عن البقاء خارجَ إطارِ هذه القاعدة.
إحدى أهم الخصائص الأولية الأخرى للدولة القومية، كونها تتميز ببنيةٍ منغلقةٍ قدرَ الإمكان إزاءَ الكيانات السياسية التعددية والمختلفة عنها. وسببُ ذلك مفهوم. ذلك أن الكيانات السياسية التعددية والمغايرة سوف تُشَكِّلُ حجرَ عثرةٍ على دربِ استغلال الاحتكارِ لها ضمن الحدود القائمة. فإذ ما اكتَسَبَ المجتمعُ الأخلاقي والسياسي وجودَه بكياناتٍ مغايرة بِحُكمِ طبيعته، وبالأخص الكيانات السياسية الديمقراطية؛ فإن مساحةَ الاحتكاريين سوفَ تَضِيقُ على نحوٍ خطير. ومصطلحاتُ استحالةِ اقتسامِ الهيمنة، وحدة الوطن، والبنية المركزية وغيرها، إنما ابتُكِرَت لهذا الغرض. المَرامُ هنا هو عدم اقتسام قِيَم البلد مع شعبه ومجموعاتِ مجتمعه. هذه الذريعةُ تؤدي دوراً رئيسياً حتى في إبادةِ الثقافة المعنوية أيضاً. فبالرغم من كون التعدديةِ السياسيةِ الديمقراطيةِ النظامَ الأنسبَ للحريةِ وللمساواة المتأسسةِ على التباين؛ إلا أنها تُعكَس بوصفها آراءً وممارساتٍ خارجةً عن القانون، و"تُهَدِّدُ وحدةَ الوطن ونظامَه".
الدولةُ القوميةُ ربما هي الممثل الأكثر تواطؤاً مع القوةِ المهيمنة من خلال الهوية القوموية التي تُحَفِّزُها وتُفَعِّلُها بالأكثر. أي أنها العميل الأوفى المتواطئ مع النظام الرأسمالي العالمي تحت غطاءِ القوموية. ما مِن قوةٍ بقدرِ الدولة القومية تابعة وخادمة للقوة المهيمنة، أي لقوةِ الرأسمالية العالمية المحورية. وكونها استعماريةً داخليةً ينبع من طابعها هذا. بقدرِ ما تتشبث أيُّ دولةٍ قومية بالقوموية، تَكُون حينئذٍ خادمةً بالمثل للقوةِ المهيمنة للنظام العالمي. من هنا، أما الدولةُ القومية - التي أَعَدَّتها القوةُ المهيمنةُ بعنايةٍ فائقة، وحَدَّدَت ملامِحَها، وصَيَّرَتها بذاتها نظاماً طيلة أربعة قرونٍ بأكملها – فالاعتقاد بأنها الدولةُ الأكثر قومويةً، مفادُه عدمَ فهمِ أيِّ شيءٍ من حروبِ قوةِ النظام الرأسمالي العالمي المهيمنة بذهول.
لدى تحليل مصطلح الدولة القومية، من المهم بمكان عدم الوصول إلى نتائج خاطئة بالخلط بينه وبين بعض المواضيع الأخرى. ينبغي أولاً تعريفَ مصطلح الدولة القومية بشكلٍ حسن. فالدولُ تاريخياً كانت تُعَرِّفُ نفسَها عموماً بكونها تنظيماً محدوداً بأعضائه المنتمين إليه. أي أنها كانت في وضعِ قَبولها وتَبَنِّيها متمثلةً في شخصِ كوادرِ الدولة، وإقناع بعضهم بعضاً، وإضفاء هالة من السمو والنبالة على بعضهم بعضاً، بل وحتى تأليههم لبعضهم بعضاً. وقد تَغَيَّرَ هذا التعاطي مع الدولة القومية. حيثُ تم العبور صوبِ وضعٍ تَعرضُ فيه ذاتها على أنها بمثابةِ عَظَمَةِ إله الدولةِ القومية وسموه وقدسيته، ولم تقتصر في إقناع كوادر الدولة وحسب بذلك، بل وعَمَّمَته على عموم المجتمع المؤلَّفِ من أَتباعِها المسمين بالمواطنين. وكأن المجتمعَ برمته قد صُهِرَ في بوتقةِ الدولة القومية. هذا هو الحدث المسمى بالحبس في القفص الحديدي. ومن المحال إدراك الدولة القومية أو الحداثة، ما لم تُفهَمْ هذه الحقيقة. أولاً؛ تقييم الدولة القومية مع الجمهورية والديمقراطية. فمثلما أن الدولةَ القومية ليست بجمهورية، فهي قد تصاعدت بالتأسيس على التضاد مع فلسفةِ الجمهورية ومؤسساتها وآلياتها الأساسية. أي أن الدولةَ القوميةَ إنكارٌ لميول الجمهورية. من هنا، فالرأي الذي لا يزال طاغياً في اليسار، ويُعَدُّ الرأي الرسمي ليسار الاشتراكية المشيدة طيلة قرن ونصف، والذي مفاده "الديمقراطية والاشتراكية مستحيلتان دون الدولة القومية المركزية"؛ إنما هو خداعٌ فظيعٌ للذات. ونتائجه الوخيمة قد شوهِدَت في تصفيةِ عددٍ جَمٍّ من الاشتراكيين والديمقراطيين في ألمانيا خصيصاً، وعلى رأسهم روزا لوكسمبورغ؛ وتمت معاناتها في انهيارِ نظامِ الاشتراكية المشيدة. ما مِن ضلالٍ أو زيغٍ آخَر ألحَقَ الخسائر الفادحة بهذا الكم بالاشتراكية والديمقراطية. لا يمكن للجمهورية والديمقراطية أن تتميزا بمعانيهما الحقيقة، إلا عبر كيانات السياسة الديمقراطية التعددية المقابلة لاحتكارية الدولة القومية. حينها فقط يَكُون بالإمكان تحقيق الجمهورية الديمقراطية من خلال نَسَقِ السياسة الديمقراطية التعددية، لِتَسودَ الحياةُ المشتركة ضمن التباين والاختلاف، وتَعُمَّ الروح الوطنية القَيِّمَة.
يُلاحَظ في راهننا مساعي احتكارات رأس المال المالي العالمي في إعاةِ إنشاء الدول القومية ذات البنى القديمة ضمن الشروط التي تَهرَع فيها وراء الهيمنة. ونزعةُ النيوليبرالية تلك أمرٌ مفهوم، وإنْ كانت تَرمي إلى أهداف مغايرة ومختلفة (وبالأخص تضليلها بالقناعِ الديمقراطي). فالاحتكار الوطني عاجزٌ عن الحذوِ حذوَ الاحتكار العالمي من جوانب عديدة، وعن الولوجِ بسرعة في تلبيةِ متطلبات السياسات العالمية حيزَ التنفيذ. بالتالي، فهو يتسبب بالانسداد فيما يتعلق بتَكامُل النظام. أي أن إعادةَ الإنشاء لا ترمي إلى القضاء على الدولة القومية، بل إلى إرفاقِها برَغباتِ رأس المال المالي الجديد المهيمن عالمياً.
لا تتردد الدولةُ القومية في استخدامِ الصياغاتِ الأيديولوجيةِ الأربع الرئيسية بشكلٍ متداخل وتوفيقيٍّ متمفصل لِبَسطِ هيمنتها الأيديولوجية وتسريبها إلى صفوف المجتمع. فالقومويةُ، التي تُعَدُّ الشكلَ الأيديولوجيَّ الأساسي للدولة القومية، قد طُبِعَت بجوهرٍ دينيٍّ محض. فبقدرِ ما تَكُونُ الدولةُ القوميةُ حداثةً رأسماليةً، فالقومويةُ أيضاً دينٌ حداثيٌّ بالمثل. حيث أُعِدَّت بوصفها الدينَ الاجتماعيَّ للفلسفة الوضعية. ينبغي التفكيرَ بالوطنية على أنها ضد المجتمع الوطني، بوصفها طبيعةً اجتماعية. بهذا المعنى، فالقومويةُ أيديولوجيةٌ مناهِضةً للأمة بأعلى المستويات. فبشرطِ إخضاعِها الأمةَ – التي تُعتَبَر ظاهرةً ديمقراطية – للهيمنةِ الأيديولوجية الرأسمالية من خلال القوموية، تَكُونُ قد قَدَّمَت أعظم خَدَماتها للاحتكاراتِ الاستغلالية. وتُحَوِّلُ الأمةَ إلى مُلكٍ ومستعمَرةٍ مشترَكَين إلى أقصى الدرجات للاحتكارات المتحالفة فيما بينها (الاحتكارات التجارية، الصناعية، المالية، والسلطوية). وتؤدي وظيفتها هذه على وجه الخصوص تحت رداءِ الدين القوموي الوضعي لأقصاه. القومويةُ باعتبارها دينَ الدولة القومية تُظهِرُ نفسَها بجانبها هذا على شكلِ ظاهرتَين مختلفتَين تنبعان من الأساس عينه، وإنْ بَدَتا وكأنهما متناقضتَين ظاهراً.
أُولاهما هي على نحوِ ألوهيةِ "الدولةِ المركزية". وهي حساسةٌ للغاية ضمن الأمة باعتبارها دولةَ الإله الواحد. وفي الساحة الدولية يَنعكِسُ هذا الإلهُ الواحد على شكلِ قوةٍ مهيمنةٍ خارقة (وقولُ ج. و. بوش G. W. Bush، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها القوة المهيمنة بامتياز، خيرُ برهانٍ على ذلك عندما أشار إلى أنه مُكَلَّفٌ باسم الرب). والقوةُ المهيمنةُ الخارقة هي "حالةُ الإله الهابط على وجه الأرض" على حد تعبيرِ هيغل (ولو أنه كان قال ذلك في نابليون وفرنسا في ذاك العهد). ثانيتُهما؛ كلُّ دولةٍ قومية وثنُ أمةِ القوة المهيمنة بامترايز، كونَها إلهاً. وإكثارُها لنفسِها بهذا الشكل لا يعني تَمَزُّقَ أوصالها ووحدتها أو التوجه صوب نظامٍ متعدد الآلهة، بل يعني إكثارَها بوصفها أوثاناً. ومنبعُ ذلك هو الفلسفة الوضعية. أي أن الأيديولوجيةَ التوفيقيةَ الثانيةَ للدولة القومية هي العلموية الوضعية. وهي المصدر الأيديولوجي الأدنى إلى القوموية. إذ تقتات كِلتاهما على بعضهما البعض. ومؤسِّسُها أوغست كومت كان قد جَهِدَ بنفسه لإنشاء الوضعيةِ ديناً دُنيَوِيّاً كونياً مطلقاً. لكنه لم يفلح بقدر الماركسية. مع ذلك، فهي بمثابةِ الدين الأساسي للعلمانية. لدى تقييم نيتشه للفلسفةِ الوضعيةِ بأنها الميتافيزيقيا السُوقِيَّةُ المُبتَذَلةُ الأكثر فظاظةً، وبالرغم من زعمه بتضاده معها؛ إلا أنه كان مُحِقّاً في ذلك كثيراً، حيث يطرح تشخيصاً جد مهم. وباعتبارها إحدى التعديلات (الاشتقاقات) الأيديولوجية المحبَّبة للحداثة، فهي الأيديولوجيا المهيمنة الأكثر تحريفاً وتعميةً وتوثيناً لعِلمِ الاجتماع.
الوضعيةُ أيضاً كعِلم (العلموية) هي فلسفةُ الظواهريةِ الأكثر فظاظةً. فالظاهرةُ مظهَرُ الحقيقة، بينما في الوضعيةِ هي الحقيقةُ بذاتها. وكلُّ شيءٍ ليس بظاهرةٍ ليس حقيقياً. إننا نَعلَمُ من خلالِ فيزياء الكَم (كوانتوم) وعلم الفلك والبيولوجيا، بل وحتى من جوهر الفكر بِحَدِّ ذاته، أن النسبةَ العظمى من الحقيقةِ تسري في عوالمِ ما وراء الحوادث الظاهرة للعين. لقد أُحِيطَت الحقيقةُ بماهيةٍ سرية لأقصاها في العلاقة بين الملاحِظ والملحوظ، بحيث بلغت حداً لا تندرج في أيِّ معيارٍ أو تعريف. والفلسفةُ الوضعيةُ هي الأكثر شَبَهاً بوثنيةِ (Paganizm) العصور القديمة، بوصفها إنكارَ هذا العمق الغائر. ولِظُهورِها كظاهرةٍ وثنية، فهي تَعكِسُ الأواصرَ المشتركة بين الوثنية والوضعية. لهذا السبب بالذات، فجميع الذهنيات المغسولةِ بدين القوموية ضمن الدولة القومية، إنما تَعتَقِدُ أن العالَمَ مجرد مظاهر (ظواهر) بسيطة، وتَفهَمه ضرباً من ضروبِ العبادة. وتَشَبُّثُ المجتمع الاستهلاكي بـ"الموضوع الشيء Nesne" هو تلك العبادة بذاتها. وبجانبه هذا، فتَشَكُّلُ المجتمعِ الاستهلاكي بوصفه ثمرةَ أوساط الدولة القومية، إنما هو أمرٌ هام ومُدرَك لأبعد الحدود. هكذا، وبينما يُقَدِّمُ جميعُ أفرادِ المجتمعِ فرصةَ الربح المفرط للاحتكارات الرأسمالية، كونهم أسيري السلع واستهلاكيين بإفراط (لقد باتت السلعةُ وثناً بنحوٍ كلي في الدولة القومية والمجتمع الاستهلاكي)؛ فمن الجانب الآخر، إن المجتمعَ الأسيرَ من خلالِ نزعةِ الاستهلاك المصبوغة بضربٍ من ضروبِ المَظهَر الديني، يصبح المجتمعَ الأكثر طاعةً وخنوعاً وانصهاراً، والأكثر يُسراً في التحكم به وإدارته. والمجتمعُ القومويُّ بدرجةٍ مُهَوِّلة، والثابت على الذهنية الشعاراتية؛ إنما يُعَبِّرُ عن هذه الحقيقة بكل علانيةٍ وشفافية.
الصياغةُ الأيديولوجيةُ الثالثةُ الهامة هي التعصب الجنسوي الاجتماعي. الجنسانية أيضاً كانت السلاحَ الذي طالما لجأت إليه نظم المدنية على طول التاريخ (في مواجهةِ المجتمعِ الأخلاقي والسياسي). واستعمارُ المرأةِ لِمَآربَ عديدة خيرُ سَردٍ ملفتٍ للنظر بهذا الصدد. فهي تُنجِب الذُّرِّيَّةَ، وهي عامِلٌ مجانيٌّ بلا أَجر، وصاحبةُ أكثر الأعمال قَهراً ومشقة، والعبد المطيع لأقصاه. كما أنها بمثابةِ الموضوعِ الشيء Nesne الذي تُمارَس عليه الشَّهوة الجنسية، وأداةُ الدعاية. هي أثمن سلعة، بل ومَلِكَةُ السلع. هذا ويُنظَر إليها على أنها المصنعُ الذي يُزاوِلُ الرجلُ سلطتَه عليه بوصفها أداةَ الاغتصاب الدائم. وهي المُحَقِّقَةُ لديمومةِ المجتمعِ الذكوري المهيمن معنوياً، باعتبارها موضوع Nesne الجمال والصوت والزينة. تَبلُغُ مكانةُ المرأة أقصى مراتبِها بجميعِ جوانبها هذه ضمن المجتمع الذكوري المُحتَوى في بنيةِ الدولة القومية. فتَصَوُّرُ المرأة باعتبارها إلهةً في مجتمعِ الدولة القومية (هويةُ وتَصَوُّرُ المرأة المشتركة)، تَبدو ظاهرياً وسيلةً للعبادة. لكن صفتَها بكونها "إلهة"، إنما تعني هنا أَدنى المراتب وبيوتَ الدعارة. فالمرأةُ الإلهة هي المرأة المُتَعَرِّضةُ لأقصى درجاتِ الإهانة والسفالة. بينما تُضفي الجنسانيةُ في مجتمعِ الدولة القوميةِ طابعَ السلطوية العظمى على الرجل من جانب (كل رجلٍ متسلط يَنقُشُ العلاقةَ الجنسيةَ في عقله بشكلٍ مستورٍ بما مفاده "أنهَيتُ أمرَ الفاحشة" و"تَمَكَّنتُ منها")، فهي من الجانب الآخر تُحَوِّلُ المجتمع إلى مستعمَرةٍ في الحضيض متمثلاً في شخص المرأة. بهذا المعنى، فالمرأةُ في الدولة القومية بمثابةِ أمةِ المجتمع التاريخي المستعمَرة بأرقى الأشكال!
لا تتخلف الدولةُ القوميةُ عن استخدام الدين باعتباره شريعةَ ما قبل الحداثة، بالتداخل مع الأيديولوجيةِ القوموية. الدافعُ وراء ذلك هو تأثيرات الدين التي لا تزال منيعةً في المجتمعات. وبالأخص الإسلام، الذي لا يَبرحُ حيوياً للغاية في هذا المضمار. لكن الشريعةَ الدينية لم تَعُدْ الدينَ القديمَ مع نمطِ استخدامِها في الحداثة. فالدينُ المستَخدَم في الحداثة ضمن إطارِ الدولة القوميةِ مبتور من وظيفته الاجتماعية الحقيقية (دوره العظيم في المجتمع الأخلاقي والسياسي)، ومَعروضٌ بحالته المَخصِيَّة؛ سواءً كان راديكالياً أم معتدلاً. فدوره في المجتمع يندرج في المعايير التي تَأذَنُ بها الدولةُ القومية، حيثُ تُوضَع العراقيلُ الصارمةُ أمام استمراره بوظيفته الإيجابية داخل المجتمع الأخلاقي والسياسي. والعلمانيةُ تتصدر لائحةَ العراقيل في هذا السياق. بالتالي، ينبغي عدم الاستغراب من انفجارِ النضالات والنزاعات فيما بينهما بين الفينة والأخرى. هذا وعدم تَخَلِّي الدولة القومية كلياً عن الدين (بوصفه شريعةً قديمة)، إنما يتأتى من بنيته المساعدة كثيراً لاستثمارها وتَصييرها قومويةً، إلى جانبِ ثِقَلِ وزنه الكبير على المجتمع. وأحياناً يؤدي الدينُ بذاته دورَ القوموية. فالمذهب الشيعي المعروض في إيران، هو السلاحُ الأيديولوجي المهيمن الأعتى للدولة القومية الإيرانية الراهنة. ذلك أن المذهبَ الشيعي مثالٌ قومويٌّ للدين الأرقى. وأشباهُه كُثُر. فالمذهبُ السُّنِّيُّ في تركيا بمثابةِ الأيديولوجيا الدينية الأدنى إلى القوموية والأسهل انزلاقاً نحوها، ولو بحدود.
الدولةُ القوميةُ التي تأخُذُ على كاهلها مَهَمَّةَ تحقيقِ الاستغلال الاحتكاري ذي الطوابق الأربعة الموَحَّدة (الاحتكار التجاري والصناعي والمالي، واحتكار السلطة)، لا تكتفي باستخدامِ الفاشية فقط بوصفها الشكلَ الأكثر هَولاً للعنف لتنفيذ مآربها تلك. ذلك أن ذلك يَشتَرِطُ الاستخدامَ المهيمن للأيديولوجيات التوفيقيةِ الأربع بمثلِ استخدامِ عنفِ النظام الفاشي بأقل تقدير. حيث يستحيلُ الاستمرار بالنظام الفاشي دون الهيمنةِ الأيديولوجية.
الإنسانُ النَّمَطِيُّ (الأحادي النمط) ومجتمعُ حشدِ الرعاع، اللذان تسعى الدولةُ القوميةُ العصريةُ لتطويرِهما وفق الأسلوب الذي ترتأيه من خلال المسار الكوني المستقيم والتقدمي المُطلَق (مفهوم الأسلوب المنغلق تجاه الاحتمالات والبدائل)؛ تَرُدُّ العصرانيةُ الديمقراطيةُ عليهما من خلال الأساليبِ التعددية والاحتمالية المنفتحة على البدائل، والتي تُبرِزُ المجتمعَ الديمقراطي إلى الوسط. حيث تُطَوِّرُ بدائلَها ببنيتها المنفتحة على الكيانات السياسية المختلفة، وذات التعددية الثقافية، المنغلفة على الطابع الاحتكاري، الأيكولوجية، الفامينية، والتي تلبي الاحتياجات الاجتماعية الأولية، وببنيتها الاقتصادية المرتكزة إلى السلوك الجماعي. الكونفدراليةُ الديمقراطية هي البديلُ السياسيُّ المقابل لدولةِ الحداثةِ الرأسماليةِ القومية.
الكونفدرالية الديمقراطية:
-aمنفتحةٌ على الكيانات السياسية المختلفة والمُعَقَّدة للغاية. ذلك أن الكيانات السياسية المختلفة عامودياً وأفقياً ضرورةٌ اضطراريةٌ بسبب البنية المعقدة للمجتمع القائم. هذا وتَلُمُّ شَملَ الكيانات السياسية المركزية والمحلية والإقليمية ضمن حالةِ توازن. فبِحُكمِ ردِّ كلِّ واحدٍ منها على ظروفٍ ملموسةٍ معيَّنة، فإن البنيةَ السياسيةَ التعدديةَ أقربُ إلى إيجادِ سُبُلِ الحل الأسلم والأصح للمشاكل الاجتماعية. كما أن تعبيرَ الهوياتِ الثقافية والأثنية والوطنية عن نفسها من خلال الكيانات السياسية من أكثرِ حقوقها طبيعيةً. أو بالأحرى، هي ضرورةٌ من ضرورات المجتمع الأخلاقي والسياسي. هذا وهي منفتحةٌ على أشكال الوفاق المبدئي مع تقاليد الدولة، سواءً كانت دولةً قومية أم جمهوريةً أم ديمقراطياتٍ بورجوازية. إذ بمستطاعها العيش تحت مظلةٍ واحدة على أساسِ السلامِ المبدئي.
-b تستند إلى المجتمعِ الأخلاقي والسياسي. أما مساعي المجتمع المُصاغة على شكلِ مشاريع عينية ونمطية مرتكِزة إلى هندسة المجتمع، من قبيل المجتمع الرأسمالي، الاشتراكي، الإقطاعي، الصناعي، الاستهلاكي وغيرها؛ فتَعتَبِرُها مندرجةً ضمن إطارِ الاحتكارات الرأسمالية. إذ لا وجودَ لهكذا نوعٍ من المجتمعات مضموناً، بل دعائياً وحسب. فالمجتمعاتُ أساساً سياسيةٌ وأخلاقية. والاحتكاراتُ الاقتصاديةُ والسياسيةُ والأيديولوجية والعسكرية أجهزةٌ تَقرُضُ وتَنخُرُ في طبيعةِ المجتمعِ الأساسيةِ تلك، طمعاً بفائض القيمة، بل وحتى بالجزيةِ الاجتماعيةِ الثقيلة. ذلك أنها لا قيمةَ لها بمفردها. فحتى الثورةُ لا تَقدِرُ على خلقِ المجتمعِ الجديد. إذ لا يمكنها إلا أن تؤدي دوراً إيجابياً بوصفها حملاتٍ تمشيطية يُلجَأُ إليها في سبيل البلوغِ بالنسيجِ الأخلاقي والسياسي للمجتمع إلى وظيفته الأصلية بعد أن كان مُعَرَّضاً للضمورِ والتهشش. وما يتبقى تُحَدِّدُه الإرادةُ الحرةُ للمجتمعِ الأخلاقي والسياسي.
-c تعتمد على السياسةِ الديمقراطية. فمقابلَ مفهومِ الدولةِ القوميةِ في الإدارةِ والحكم الصارمِ المركزيِّ البيروقراطي ذي المسار المستقيم، تُشَكِّلُ جميعُ المجموعاتِ الاجتماعية والهويات الثقافيةِ الإدارةَ الذاتيةَ للمجتمعِ من خلال الكيانات السياسيةِ المُعَبِّرَةِ عنها. ويتم تدبير الشؤون والأعمال في مختلف المستويات، عن طريقِ الإداريين القائمين على وظائفهم بالانتخاب، لا التعيين. المهم هو كفاءةُ إصدار القراراتِ المَجالِسية المُتَداوَلة. أما الإداراتُ المستقلة، فغيرُ دارجة أو مقبولة. تتحقق الإدارةُ والمراقبةُ الديمقراطية بصدد الأعمال الاجتماعية من خلال حزمةِ الهيئات المتعددة البنى، والمتطلعة إلى الوحدة ضمن إطارِ التباين والاختلاف، والمناسِبة لبنيةِ كلِّ مجموعةٍ وثقافة، بدءاً من الهيئة التنسيقية المركزية العامة (مجلساً كانت أم لجنة أم مؤتمراً)، وصولاً إلى الهيئات المحلية.
-d ترتكِز إلى الدفاع الذاتي. وحداتُ الدفاع الذاتي قوةٌ أساسيةٌ، لا بوصفها احتكاراً عسكرياً، بل بخضوعها لمراقبةِ الأجهزةِ الديمقراطية المُشَدَّدة بما يُلَبّي احتياجات المجتمع الأمنية الداخلية والخارجية. تتجسدُ وظيفتها في تفعيل إرادةِ السياسة الديمقراطية للمجتمع الأخلاقي والسياسي بوصفه بنيةَ القرار الحر المعتمِدِ على المساواة تأسيساً على الاختلاف والتباين. كذلك شلُّ تأثيرِ تَدَخُّلاتِ القوى العاملة على إفراغ هذه الإرادة أو عرقلتها أو القضاء عليها، سواءً خارجياً أم داخلياً. البنيةُ القياديةُ للوحدات تَخضَعُ للمراقَبةِ المزدَوَجة من قبل أجهزةِ السياسة الديمقراطية وأعضاءِ الوحداتِ على السواء، ويمكن تغييرها بسهولة عندما تقتضي الحاجة من خلال الاقتراحات والمُصادَقاتِ المتبادَلة.
-e لا مكانَ فيها للهيمنةِ عموماً وللهيمنةِ الأيديولوجيةِ على وجهِ الخصوص. فالمبدأُ المهيمن ساري المفعول في المدنيات الكلاسيكية. بينما في الحضاراتِ والعصرانيةِ الديمقراطية لا يُنظَرُ بعينِ القَبولِ أو الاستساغة إلى القوى والأيديولوجيات المهيمنة. ولدى تَخَطّي حدودِ التعبيرِ المغاير والإدارةِ الديمقراطية، يُشَلُّ تأثيرُ ذلك من خلالِ الإدارةِ الذاتية وحريةِ التعبير. المفهومُ المتبادَل، واحترامُ المقتَرَحاتِ المختلفة، والالتزامُ بأسسِ القرار الديمقراطي شروطٌ لا بد منها في الإدارةِ الجماعيةِ لشؤونِ المجتمع. وبالرغم من تَقاطُعِ مفهومِ الإدارةِ في المدنيةِ الكلاسيكيةِ والحداثةِ الرأسمالية مع مفهومِ الإدارةِ في الدولة القومية بصدد هذا الموضوعِ؛ إلا أنه ثمة فوارقُ وحالاتُ شذوذ كبرى بينهما وبين مفهومِ الإدارةِ في الحضارةِ والعصرانية الديمقراطيتَين. فنمطُ الإدارةِ البيروقراطية المزاجية ونمطُ الإدارةِ الديمقراطية الأخلاقية يَكمنان في أساسِ الفوارقِ وحالاتِ الشذوذِ والخِلاف.
هذا ولا يمكن الحديث فيها عن الهيمنةِ الأيديولوجية بتاتاً. الأمرُ سارٍ على التعددية والآراءِ والأيديولوجيات المختلفة أيضاً. ولا حاجةَ للإدارةِ لِتَعزيزِ ذاتها بالتمويه الأيديولوجي. بناءً عليه، ومثلما لا ترى داعياً للأيديولوجياتِ القوموية والديانوية والعلموية الوضعية والتعصبية الجنسوية، فهي مضادةٌ لبسطِ الهيمنةِ أيضاً. كلُّ رأيٍ وفكرٍ وعقيدةٍ له الحق في التعبير عن ذاته بِطَلاقةٍ وحرية، طالما لا يتخطى بنيةَ المجتمعِ الأخلاقيةَ والسياسيةَ، ولا يَطمَع في بسطِ الهيمنة.
-f المجتمعات الوطنية مَيَّالةٌ للاتحاد الكونفدرالي الديمقراطي العالمي مقابلَ مفهوم الاتحادات على شاكلةِ هيئة الأمم المتحدة التي تَتَّبِعُها الدولُ القومية الخاضعة لمراقبةِ وإشرافِ القوة المهيمنة الخارقة. ذلك أن توحيدَ المجموعات الأوسع نطاقاً بكثير كَمّاً ونوعاً على السواء تحت مظلةِ الكونفدرالية الديمقراطية العالمية حسبَ معاييرِ السياسة الديمقراطية، إنما هو شرطٌ أوليٌّ من أجلِ عالَمٍ أكثرَ أمناً وسلاماً وأيكولوجيةً وعدالةً وإنتاجية.
خلاصةً، فالفوارقُ ونقاطُ التضادِّ القائمةِ بين العصرانيتَين الرأسمالية والديمقراطية، والتي يمكننا المقارنةَ بينها بمنوالٍ أوسع بكثير؛ ليست مجرد هدفٍ مثالي وحسب، بل هي دليل على عالَمَين كبيرَين معاشَين في الواقع الملموس. هذان العالَمان اللذان تحاربا أحياناً بلا هوادة كقُطبَين متضادَّين جَدَلياً، مثلما لم ينقص السلام والوفاق بينهما بين الفينة والأخرى على مر مسيرتهما التاريخية؛ إنما هما في راهننا أيضاً على صراعٍ فيما بينهما أحياناً وضمن وفاقٍ سلمي أحياناً أخرى بشكلٍ مشابه وبكلِّ علاقاتهما وتناقضاتهما. لا ريب أن النتيجةَ النهائيةَ سوف يُحَدِّدُها مَن يَنفُذُ مِن الأزمة البنيوية المنهجية القائمة بتحقيق الانطلاقةَ السليمة والحسنة والجميلة فكرياً وسياسياً وأخلاقياً.