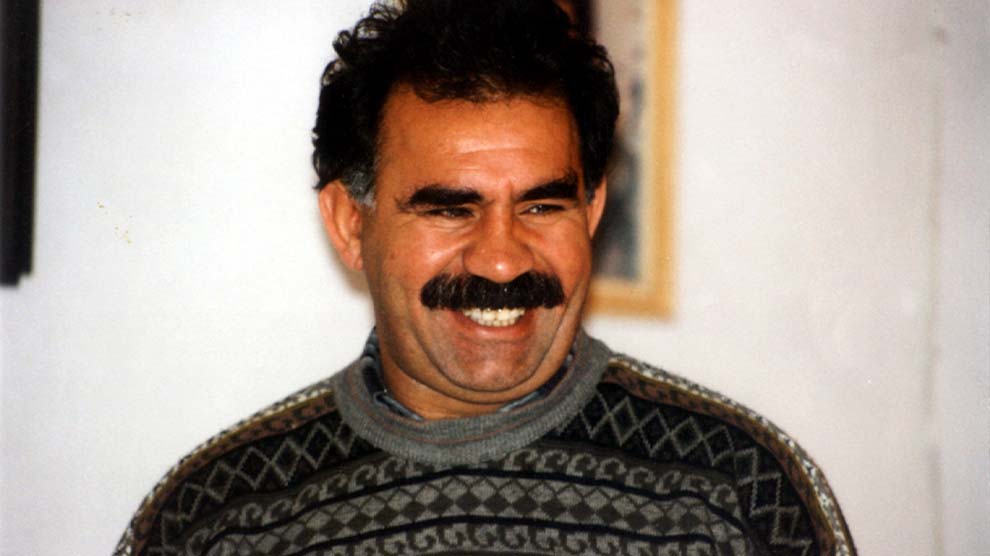قد لا يُمكنُ صياغة تعريف الحياة. أو بالأحرى، قد نشعرُ بها نسبياً، أو نُدركُها جزئياً. فبالرغمِ من كونِ التطورِ التدريجيِّ حقيقةً قائمة، إلا أنّ إيضاحَ التفسيرِ التطوُّريِّ الداروينيِّ لتطورِ الحياةِ والكائناتِ الحيةِ بعيدٌ عن إظهارِ الحقيقة.
كما أنّ رَصدَ حياةٍ تبدأُ من كائنٍ حيٍّ لَم يصبحْ خليةً بَعدُ في أغوارِ المحيطِ قبل ثلاثةِ ملياراتِ سنةٍ من الآن، وتَصِلُ إلى إنساننا الراهن بمنوالٍ تسلسليّ، إنما يساهِمُ بشكلٍ محدودٍ في تحديدِ معنى الحياة. يبحثُ العلمُ حالياً عن أسرارِ الحياةِ في تكويناتِ الجُسَيماتِ ما تحتِ الذّرّيّة. ولكن، واضحٌ جلياً استحالةُ الذهابِ أبعدَ من إيضاحٍ محدودٍ للحياةِ بهذا الأسلوبِ أيضاً. للحياةِ صِلاتُها مع هذه السرودِ بكلِّ تأكيد، ولكنها لا تَحلُّ المشكلةَ تماماً. هذا ومقارنةُ الحياةِ بالموتِ أيضاً لا تكفي لإدراكِ معناها. أي أنّ القولَ بأنّ "الحياة هي ما قبلَ الموت" ليسَ نمطاً إيضاحياً مُقنِعاً كثيراً. الأصحُّ هو أنّ الحياةَ غيرُ ممكنةٍ إلا بالموت. أعلَمُ أنّ الحياةَ الخالدةَ مستحيلة. ولكننا بعيدون أيضاً عن معرفةِ معنى الموت. تعريفُ الموتِ أيضاً غيرُ ممكن، كما الحياةُ بأقلِّ تقدير. فربما هو مُحَصِّلةٌ نسبيةٌ لحياتنا. وربما هو إمكانيةٌ في الحياةِ أو نمطُ تَحَقُّقِها. وخشيةُ الموتِ علاقةٌ اجتماعية، مثلما سأُعَرِّفُها بإسهابٍ لاحقاً. وربما الموتُ هو شيءٌ مِن قبيلِ هذه الخشية.
لا أرى ثنائيةَ المثاليةِ – الماديةِ مبدئيةً وإيضاحية. إذ لا قيمةَ لهذه الثنائية، التي يَطغى عليها طابعُ المدنية، في تعريفِ أو شرحِ الحياة. وبالنسبةِ إلى ما أَوَدُّ صياغته من تفسير، أُريدُ التأكيدَ على أنّ علاقةَ هذه القرينةِ محدودةٌ مع الحقيقة. وبمنوالٍ مشابه، فمصطلحاتُ الحيّ – الجامد أيضاً بعيدةٌ عن الإيضاحِ فيما يتعلقُ بالحياة.
الحقيقة الأولى: قد يَعيشُ كلُّ كائنٍ حيٍّ – جامدٍ لحظاتِه فقط، فيما خَلا الإنسان الذي يسعى لإدراكِ الحياة. فربما أنّ الخروفَ الذي انقضَّ عليه الذئب، والمَجَرَّةَ التي ابتَلَعَها الثقبُ الأسودُ يتشاطران المصيرَ الكونيَّ نفسَه. وحتى هذا مجردُ لغزٍ لأجلِ فهمِ الحياة، لا غير.
الحقيقة الثانية: الكائنُ الحيُّ الذي يُمَزِّقُ نفسَه ويُرهِقُها لأجلِ مَولودِه، وإنجازُ الجُسَيماتِ ما تحتِ الذّرّيّةِ تكويناتٍ دياليكتيكيةً بسرعةٍ خاطفةٍ لا تُصَدَّق، إنما يَعمَلان بِحُكمِ القاعدةِ الكونيةِ عينِها.
الحقيقة الثالثة: بَلَغَت هذه القاعدةُ الكونيةُ بنفسِها إلى منزلةِ مساءلةِ الذاتِ في المجتمعِ البشريّ: مَن أنا؟ هذا السؤالُ هو سؤالُ محاولةِ القاعدةِ الكونيةِ لإسماعِ ذاتِها لأولِ مرة.
الحقيقة الرابعة: قد يَكُونُ الردُّ على سؤالِ "مَن أنا؟" هو الهدفُ النهائيُّ للكون.
الحقيقة الخامسة: ربما الحياةُ الكونيةُ برمتِها من حيٍّ وجامدٍ هي في سبيلِ تأمينِ بلوغِ السؤال "مَن أنا؟".
الحقيقة السادسة: "أنا هو أنا، أنا الكون، أنا الزمكانُ الذي لا قَبلَ له ولا بَعد، لا قُربَ له ولا بُعد!" ربما هذا الجوابُ هو الهدفُ النهائي.
الحقيقة السابعة: الفناءُ في الله، النيرفانا، أنا الحق. هذه الحِكَمُ المُطلَقةُ ربما كَشَفَت عن الهدفِ الأساسيِّ لحياةِ الإنسانِ الاجتماعية، أو أنها أَظهَرَت للوسطِ اهتمامَها بالحياةِ الاجتماعية.
بهذه الحقائقِ السبعِ لا أَكُونُ قد عَرَّفتُ الحياة. بل أَبحَثُ في الميادينِ المعنية، أو أَوَدُّ البحثَ فيها. لا تُدرَكُ الحياةُ أثناءَ عيشِها. ثمة هكذا تناقضٌ بين المعنى والحياة. فعندما يَكُونُ العاشقُ مع معشوقِه، فهو في الوقتِ ذاتِه في المكانِ الذي ينتهي فيه المعنى. لذا، فالتمكنُ من الفهمِ المطلقِ يقتضي الوحدةَ والعزلةَ المطلقة، أي أنْ يَكُونَ بلا معشوق. فكأنّ المَثَلَ الشعبيَّ "إما الحبيبُ أو الرأس " يَوَدُّ الإشادةَ بهذه الحقيقةِ بمعناها الميتافيزيقيِّ، لا الجسديّ. فتَحَمُّلُ الوحدةِ المطلقةِ غيرُ ممكنٍ إلا بالقابليةِ لفهمِ المطلق. والوحدةُ المطلقةُ لا تتحققُ إلا ببلوغِ حالةِ قوةِ المعنى فحسب، أي بالخروجِ من كينونةِ علاقةِ القوةِ الماديةِ فقط، لا غير. قرينةُ الوجود – العدم شبيهةٌ بثنائيةِ المعنى – المادة. فكِلا الثنائيتَين مُجَرَّدتان ولا تُعاشان في الواقعِ الملموس. ويطغى احتمالُ كونِ الحياةِ هي القابليةُ اللانهائيةُ لهاتَين القرينتَين في الترتيبِ والانتظام. ويَبدو فيما يَبدو أنّ الفواصِلَ البَينِيّةَ لحالاتِ الانتظامِ ضرورةٌ حتميةٌ لِتَحَقُّقِ الحياة، ولو أنها تَظهرُ في هيئةِ لحظاتٍ فوضويةٍ عدميةٍ وعمياء مثلما الموت.
سعيتُ في هذا التحليلِ المقتَضَب، ولو بحدود، إلى شرحِ أسبابِ استحالةِ التعريفِ التامِّ للحياة. فالتعريفُ المطلقُ للحياةِ يقتضي الوحدةَ والعدمَ واللامادةَ بشكلٍ مطلق. ولأنّ هذا يَظَلُّ مجردَ تجريدٍ محض، فبلوغُ الحياةِ أو معناها غيرُ ممكنٍ إلا بنحوٍ ثنائيٍّ ونسبيّ.
بالرغمِ من كونِ الحياةِ الاجتماعيةِ مصطلحاً بسيطاً للغاية، إلا أنه يقتضي الإيضاحَ كمصطلحٍ أساسيٍّ لكلِّ العلوم. وعلى النقيضِ مما يُظَنّ، فهو مصطلحٌ لَم يتمّ بلوغُ معناه، رغمَ استخدامِه الوفير. فنحن لا نَعرِفُ ما هي الحياةُ الاجتماعية. فلو كُنا نعرِفُها، لَكُنا أصبحنا حُماةً بلا هوادة لحياتِنا الاجتماعيةِ المُمَزَّقةِ إرباً إرباً تحت وطأةِ الأنظمةِ المهيمنة. الجهلُ يَسُودُ الحياةَ الاجتماعية، لا الحِكمة. وبالأصل، فما يَسري في الطرفِ المقابلِ لحياةِ الهيمنةِ هو حياةُ الجهل. ذلك أنّه يستحيلُ الاستمرارُ بأنظمةِ الهيمنة، دون إسدالِ ستارِ الجهلِ على الحَيَواتِ الاجتماعية.
سأعملُ على تعريفِ الحياةِ الاجتماعيةِ مع مُراعاةِ الطابعِ النسبيِّ للحياة. فقبلَ كلِّ شيء، لا وجودَ لحَيَواتٍ اجتماعيةٍ رَتِيبَةٍ ولا محدودةٍ ومتشابهةٍ في كلِّ مكان. فالحياةُ النسبيةُ تعني الحياةَ الوحيدةَ الواحدية. فالواحديةُ، مثلما هو معلومٌ أو ينبغي علمُه، لا تَدحَضُ الكونيةَ. فلا هناك واحديةٌ خالصة، ولا كونيةٌ خالصة. أي أنّ الواحديةَ – الكونيةَ قرينةٌ ساريةٌ بقدرِ ثنائيةِ المعنى – المادة. إذ لا تتحققُ الكونيةُ دونَ الواحديِّ الانفراديّ. وكلُّ واحديٍّ أيضاً لا يعيشُ بلا الكونية. بوسعي تقديم مثالٍ لفهمِ ذلك أكثر: فمئاتُ الورودِ المتباينةِ هي واحديّةٌ انفراديةّ. ولكن، هناك جانبٌ مشتركٌ يقتضي تسميةَ جميعِ أنواعِ تلك الورودِ بالورود. يُعَبِّرُ هذا الجانبُ المشتركُ عن الكونية. وتَسري هذه القاعدةُ في جميعِ تَنَوُّعاتِ الكون.
نظراً لمحاولتي في عرضِ الحياةِ الاجتماعيةِ بتاريخانيتِها وتنوُّعِها ضمن الفصولِ المعنيةِ من مرافعتي، فلن أُكَرِّرَ ذلك، وسأكتفي بالتذكير. ثمة نسبةٌ هامةٌ من الواقعيةِ في قصةِ هوموسابيانس (الإنسان المفكِّر)، الذي يُفتَرَضُ أنه عاشَ في شرقي أفريقيا، وأنّه يَعُودُ إلى ما قبل حوالي مائتَي ألفِ سنة على وجهِ التقريب، ويُعتَقَدُ أنه تَوَصَّلَ إلى اللغةِ الرمزيةِ قبل خمسين ألفِ سنة، وأنه خَرَجَ من مجتمعِ ما قبلَ الزراعةِ مع انقضاءِ العصرِ الجليديِّ الأخيرِ على حوافِّ سلسلةِ جبالِ طوروس – زاغروس قبل عشرين ألف سنة، ويُجمَعُ عموماً على أنه انتقلَ إلى نظامِ حياةٍ اجتماعيةٍ تتداخلُ فيها الزراعةُ القَبَلِيّةُ مع القطفِ والقنصِ منذ خمسةَ عشر ألفِ سنة تقريباً. وقد أُضِيفَت المدنيةُ المركزيةُ الممتدةُ خلالَ خمسةِ آلافِ عامٍ على نمطِ الحياةِ ذاك، الذي تَطَوَّرَ بصفتِه مجتمعِ الزراعةِ – القرية. كنتُ قد جَهِدتُ لسردِ تَقَدُّمِ ثقافةِ حياةٍ مهيمنة، وعرضِها على شكلِ خطوطٍ عامة أو ضمن مراحل – مدارات، حيث أنها أثرت حتى يومنا الراهن عبر ثنائيةٍ يمكننا تسميتها بمجتمعِ الزراعةِ – القريةِ ومجتمعِ المدينةِ – التجارةِ – الحِرفةِ والصناعة. هذا وقد عَرَضتُ في الفصلِ السابقِ سياقَ هذه الثقافةِ المهيمنةِ في أوروبا خلال القرونِ الخمسةِ الأخيرة. جليٌّ أنّ هذه الثقافةَ بنشوئِها ونضوجِها، بل وحتى بأزماتِها البنيوية، مشحونةٌ أساساً ببصماتِ مجتمعِ الشرقِ الأوسط. هذه هي الثقافةُ والمجتمعُ الذي سعيتُ لسردِ معناهما. ورغمَ وفرةِ واحدياتِها الانفرادية، ورغمَ تشكيلِ الحداثةِ الأوروبيةِ إحدى أهمِّ واحدياتِها؛ إلا إنّ القيامَ بتجريدٍ وتصنيفٍ بمعنى واحديِّ الواحديات، أمرٌ ممكنٌ في كلِّ الأوقاتِ من حيثُ التوقيتِ والمكان.
حالةُ المجتمعِ بوصفِه واحدياً تُحَدِّدُ حياةَ النوعِ البشريّ. أي أنّ الواحديةَ والفرقَ بين حياةِ الإنسانِ الذي في أفريقيا وحياةِ ذاك الذي في الشرقِ الأوسط، تُحَدِّدُهما حالةُ ذاك المجتمع. بينما العِرقُ والخصائصُ الطبيعيةُ الأخرى غيرُ مُحَدِّدة. ففردُ الإنسانِ الذي بلا مجتمع، إنْ لَم يَمُتْ سريعاً، لا يَغدو إنساناً حكيماً وحسب، بل وقد يَغدو نوعاً قريباً من الحيواناتِ المتفاهمةِ بلغةِ الإشارةِ أيضاً. فالإنسانُ بلا مجتمع هو لاإنسان. ذلك أنّ أشَدَّ عقابٍ يُمكِنُ التعرُّض له هو طردُ إنسانٍ خارجَ المجتمع، أو التحولُ إلى إنسانٍ بلا مجتمع. فالإنسانُ يَستَقي كلَّ قوتِه من المجتمع. ومستوى أرقى العلومِ والحِكَمِ مرتبطٌ بالمجتمع. في حين أنّ تقييمَ الحياةِ الاجتماعيةِ على أنها محضُ كمياتٍ ومناظرَ فيزيائيةٍ بسيطة، هو أشنَعُ خيانةٍ ارتَكَبَتها الوضعيةُ بحقِّ الإنسان. من هنا، لا يُمكِنُ لبلوغِ مستوى المجتمعِ البشريِّ أنْ يَجِدَ معناه إلا كحملةٍ كونية. لِنُرَتِّبْ الخصائصَ الطبائعيةَ الأساسيةَ للحياةِ الاجتماعيةِ بصِفَتِها حملةً كونية:
- المجتمعُ بوصفِه تاريخاً. تَشَكَّلت المجموعاتُ الواحديةُ الأرقى حصيلةَ مساعي المجموعاتِ البشريةِ وجهودِها، التي امتدَّت على مدارِ ملايين السنين، ومَرَّت بشكلٍ مؤلِمٍ للغاية في الأماكنِ العصيبة، وتَطَلَّبَت كفاحاً عظيماً. وقد كانت بعضُ الأماكنِ والمراحلِ مُعَيِّنةً في الطفراتِ الاجتماعية.
- المجتمعُ بوصفِه تاريخاً يقتضي رُقِيَّ مستوى الذكاء. فمستوى ذكاءِ النوعِ البشريِّ قد حَدَّدَ مجتمعيتَه. والمجتمعيةُ بدورِها أَرغَمَت مستوى الذكاءِ هذا على التطورِ والعملِ كذهنية. فالطبيعةُ الاجتماعيةُ تتطلبُ بُنيةً مَرِنةً ذات مستوى ذهنيٍّ راقٍ.
- اللغةُ ليست وسيلةً للذهنيةِ الاجتماعيةِ فحسب، بل هي في الوقتِ نفسِه عنصرٌ بَنّاءٌ فيها. فاللغةُ هي إحدى الخصائصِ الأساسيةِ التي تَخلقُ مجتمعاً ما. كما تُطَوِّرُ بسرعةٍ فائقةٍ مرونةَ الطبيعةِ الاجتماعيةِ باعتبارِها وسيلةَ ذكاءٍ جماعيّ.
- الثورةُ الزراعيةُ هي ثورةُ التاريخِ الأكثر تَجَذُّراً وعَراقةً في ثقافةِ المجتمعِ الماديةِ والمعنوية. فقد تَشَكَّلَ المجتمعُ البشريُّ أساساً حول الزراعة. ولا يُمكِنُ التفكير بمجتمعٍ بلا زراعة. لا تقتصرُ الزراعةُ على تأمينِ حلِّ قضيةِ المَأكَلِ فحسب، بل وتُمَهِّدُ السبيلَ لتَحَوُّلاتٍ وتغييراتٍ جذريةٍ في وسائلِ الثقافةِ الماديةِ والمعنويةِ الأساسية، وعلى رأسها الذكاء، اللغة، السكان، الإدارة، الدفاع، الاستقرار، الدين، التقنية، المَلبَس، والبنية الأثنية.
- تؤدي المرأةُ دوراً رئيسياً أكثر في المجتمعيةِ مقارنةً مع الرجل، نظراً لكونِها صاحبةَ الجهودِ الدؤوبةِ على الإطلاق في تأمينِ السيرورةِ الاجتماعية. فالإنجابُ وتنشئةُ الأطفالِ وحمايتُهم تُحَقِّقُ تَطَوُّرَ المجتمعيةِ في المَسارِ الأموميّ. لذا، غالباً ما يَحمِلُ المجتمعُ هويةَ المرأةِ – الأم. ووجودُ العناصرِ المُؤَنَّثَةِ في أصولِ اللغةِ والدين، إنما يُؤَيِّدُ هذه الحقيقة. فهويةُ وحضورُ المرأةِ في مجتمعِ الزراعةِ – القريةِ يستمرّان في صَونِ قوتِهما.
- الطبيعةُ الاجتماعيةُ أخلاقيةٌ وسياسيةٌ في صُلبِها. فالأخلاقُ تُحَدِّدُ نظامَ قواعدِ المجتمع، بينما تُحَدِّدُ السياسةُ إدارتَه. وبينما تُؤَمِّنُ الأخلاقُ نظامَ المجتمعِ وبقاءَه، تَقُومُ السياسةُ بتأمينِ تَطَوُّرِه المبدِع. لذا، يستحيلُ التفكير في مجتمعٍ بلا أخلاقٍ وسياسة. فالتفسُّخُ في المستوى الأخلاقيِّ والسياسيِّ للمجتمعِ يُعاشُ بالتداخلِ مع تصاعُدِ شتى أنواعِ العبوديةِ واللامساواة.
السيرُ خلفَ الحقيقةِ يعني مساءلةَ ومحاسبةَ الظُّلمِ والباطل
مصطلحاتُ الحقيقةِ والحياةِ في سبيلِها والموتِ كَرمى لها، هامةٌ في ثقافةِ الشرقِ الأوسط. لكنّ مصطلحَ الحقيقةِ الذي ينعكسُ في الثقافةِ الأوروبيةِ على شكلِ قرينةِ النظريةِ – العملية، قد أُفرِغَ من فحواه ومُزِّقَ وأضاعَ كّلّيّاتيتَه تدريجياً. ويَبرزُ هذا الأمرُ بشكلٍ أفضل في الحداثةِ المتأخرة. حيث أُخضِعَت الحقيقةُ للاقتصادوية.
غالباً ما دَخَلَ البحثُ عن الحقيقةِ في الأجندة، عندما تَبَدَّت معالِمُ القضايا الاجتماعية. حيث تسعى مَقُولةٌ أو ممارسةٌ إلى عكسِ ذاتِها كحقيقة في هذه المراحلِ دون بُد. أما التحليلُ السوسيولوجيُّ للحقيقة، فيُظهِرُ روابطَها مع الباطِلِ والظُّلمِ بكلِّ علانية. فبينما عُرِّفَ نهبُ الكدحِ والقيمةِ الاجتماعيَّين بالباطلِ الجائر، فقد سُمِّيَ البحثُ والنبشُ في ذلك والقيامُ بمتطلباتِه بنشاطِ الحقيقة، وعُمِلَ دوماً على إجلالِه. أما عكسُ الحقيقةِ على أنها الحقّ، ومِن ثمّ المساواةُ بين الحقِّ والإله؛ فيَعكِسُ أواصرَ كِلا المصطلحَين مع المجتمعية. وهكذا تتأكدُ مرةً أخرى مصداقيةُ علاقةِ مصطلحِ الإلهِ مع الضميرِ الاجتماعيِّ خارجَ إطارِ كونِه تجريداً ميتافيزيقياً.
السيرُ خلفَ الحقيقةِ يعني مساءلةَ ومحاسبةَ الظُّلمِ والباطل. وبذلك تَكُونُ الهويةُ الاجتماعية، التي تُقَدِّمُ نفسَها على أنها الإلهُ بوصفِه الموجودَ الأسمى، قد رَدَّت على الظُّلمِ المرتَكَبِ بِحَقِّها، وحَكَمَت عليه بالعقابِ الإلهيّ. ومع ازديادِ حالاتِ الخطرِ والجُورِ المُحيقةِ بالهويةِ الاجتماعيةِ من داخلِ المجتمعِ ومن الطبيعةِ الخارجية، تمَّ التشديدُ على الهويةِ أكثر، وتمّت صياغةُ الآراءِ الكبرى (الرأي الإلهيّ = النظرية) ومزاولةُ الممارساتِ الكبرى (الأعمال الإلهية) إكراماً لها. ولهذا السببِ بالتحديد، من الأهميةِ بمكان إدراك كونِ الهويةِ الاجتماعيةِ تَقبَعُ في منبعِ الدينِ والفلسفة. يشيرُ هذا الأمرُ إلى أنّ البحثَ عن منبعِ الدينِ والفلسفةِ في مكانٍ آخَر هو عملٌ هباء.
يأتي تشويهُ وتعتيمُ وقمعُ الوقائعِ الاجتماعيةِ التاريخيةِ فيما يتعلقُ بمصطلحِ الحقيقةِ وممارستِها في مقدمةِ المآربِ التي يُعمَلُ تحقيقِها في خِضَمِّ الهيمنةِ الأيديولوجيةِ للحداثةِ الرأسمالية. حيث حُوِّلَ الدينُ والفلسفةُ إلى القومويةِ وإلى تأليهِ الدولةِ القومية. وحُصِرَت النظريةُ والممارسةُ العمليةُ بإجلالِ وتخليدِ مصطلحِ وممارساتِ الدولتيةِ القومية. واختُزِلَ العِلمُ بتوجيهٍ من الفلسفةِ الوضعيةِ إلى تحليلِ وحلِّ القضايا الناجمةِ عن دعاماتِ الحداثةِ الثلاث. وصُبَّ صراعُ الحقيقةِ العريقُ بقدرِ عراقةِ التاريخِ البشريِّ في تأمينِ المنافعِ البسيطةِ الزهيدة. وبينما أُخرِجَت المخاطرُ المُحيقةُ بالهويةِ الاجتماعية، التي هي القضيةُ الأصل، من كونِها موضوعَ الحقيقة، فقد سُعِيَ إلى إحلالِ الفرديةِ مَحَلَّها. وصُيِّرَت حقوقُ الإنسانِ موضوعَ استثمارٍ واستغلالٍ في هذا المضمار. بل وحتى إنّ الآراءَ المضادةَ للنظامِ الذي يَعرضُ نفسَه على أنه الأيديولوجيا الصحيحةُ المطلقة، لا تَجنحُ إلى إبداءِ الجرأةِ على تَخَطّي براديغما الحداثة.
بينما تَمَكَّنَت الليبراليةُ باعتبارِها الأيديولوجيةَ الرسميةَ للنظامِ القائم، من الاستمرارِ حتى يومِنا باحتكارِها المبنيِّ على اليَسارِ واليَمين. وبينما تَخلقُ الليبراليةُ كاحتكارٍ أيديولوجيٍّ للحداثةِ تَضَخُّماً في الآراءِ من جانب، فهي من جانبٍ آخَر تُنجِزُ أقصى نهبِها في هذا التضخُّم، مثلما تَستخدمُ أفضلَ ما يلائِمُها منه في تعريضِ الأذهانِ إلى القصفِ بوساطةِ أجهزتِها الإعلامية، سعياً منها إلى نيلِ النتيجةِ القصوى. أما ضمانُ احتكارِ الرأي، فهو الهدفُ النهائيُّ لحربِها الأيديولوجية. وأسلحتُها الأساسيةُ هي الدِّينَوِيّة، القوموية، الجنسوية، والعلمويةُ كدينٍ وضعيّ. ذلك أنّ مواصلةَ الحداثةِ بالقمعِ السياسيِّ والعسكريِّ فحسب أمرٌ غيرُ ممكن، من دونِ الهيمنةِ الأيديولوجية. وبينما تَجهَدُ الليبراليةُ عن طريقِ الدّينَوِيّةِ إلى بسطِ الرقابةِ على مجتمعِ ما قبلَ الرأسمالية، فإنها عن طريقِ القومويةِ تَضبطُ وتَتَحكَّمُ بمواطِني الدولةِ القوميةِ وبالطبقاتِ المتصاعدةِ حول الرأسمالية. أما مَرامُ الجنسوية، فهو كتمُ أنفاسِ المرأة. فالوظيفةُ المؤثِّرةُ والقديرةُ للأيديولوجيةِ الجنسوية، هي جعلُ الرجلِ مريضَ السلطة، والإبقاءُ على المرأةِ تتخبطُ في مشاعرِ الاغتصابِ في آنٍ معاً. وبينما تَشلُّ تأثيرَ العالَمِ الأكاديميِّ التخَصُّصِيِّ والشبيبةِ بالعلمويةِ الوضعية، فإنها بذلك تُشيرُ إليهم بأنْ لا خيارَ أمامهم سوى الالتحامِ مع النظام، ضامنةً بذلك تَكامُلَهم معه مقابل التنازلات.
تَحظى التساؤلاتُ: كيف نعيش؟ ما العمل؟ ومن أين البدء؟ بأهميةٍ مصيريةٍ تجاه الهجومِ الأيديولوجيِّ لِلّيبرالية. فقد شُلَّ تأثيرُ الأجوبةِ التي أعطاها مناهِضو النظامِ على هذه الأسئلة، على الأقلِّ إلى يومنا الحاليّ؛ في الحين الذي عَمَّ فيه تأثيرُ الأجوبةِ التي صاغَتها الحداثةُ رداً على الأسئلةِ الثلاثةِ الهامة. فنمطُ الحياةِ الذي طَوَّرَته الحداثةُ في غضونِ القرونِ الخمسةِ الأخيرة، قد تَرَكَ بصماتِه بنسبةٍ كاسحةٍ على سؤالِ كيف نعيش؟ أما في عصرِ الحداثةِ الرأسمالية، فقد صُيِّرَت أنماطُ الحياةِ نمطيةً متجانسةً بقوةِ الهضمِ وفرضِ قَبولِها بما لا مثيلَ له – ربما – في أيِّ عصرٍ من عصورِ التاريخ. حيث جُعِلَت قوالبُ حياةِ الكلِّ نمطاً واحداً تحت مظلّةِ القواعدِ الكونية. وصارت التبايُناتُ سقيمةً وقحلةً في وجهِ عملياتِ التنميط. أما التمردُّ على نمطِ الحياةِ المسماةِ بالعصرية، فيُوصَمُ بـ"الجنون"، ويُرمى به خارجَ النظامِ القائم. ونادرٌ جداً هم الأشخاصُ الذين يُبدُون الجرأةَ على مواظَبَةِ التمردِ إزاءِ تهديدِ النفي هذا.
هذا وأُجِيبَ على سؤالِ ما العمل؟ بردودٍ تفصيليةٍ منذ زمنٍ بعيد، أي منذ خمسةِ قرونٍ بأكملِها: عليكَ العيشَ بفردية، والتفكيرَ بنفسِكَ دوماً، والقيامَ بما يَقعُ على عاتقكَ قائلاً "الدربُ الوحيدُ هو دربُ الحداثة". أي، الطريقُ واضح، والأسلوبُ بائن: "عليكَ بالقيامِ بما يَفعَلُه الجميع. فعليكَ بالربحِ إنْ كنتَ ربَّ عمل. وعليكَ بالهرعِ وراءَ الأَجرِ إنْ كنتَ كادحاً. أما الانسياقُ وراء أعمالٍ أخرى، فهو مَحضُ حماقة". وفي حالِ الإصرار في العكس، فالنتيجةُ هي الانجرارُ إلى خارج النظام، البطالةُ، اللاحلّ، والاهتراء. لقد حُوِّلَت الحياةُ إلى سِباقِ خُيُولٍ مُهَوِّلٍ بكلِّ معنى الكلمة. لِنَدَعْ جانباً النظرَ في: ما العمل، فالجوابُ على سؤالِ: من أين البدء؟ قد صِيغَ من قِبَلِ النظامِ على شاكلةِ: "ابدأْ من المكانِ الذي دَرَّبتَ فيه نفسَكَ بمتانة". فالمدارسُ والجامعاتُ أمكنةُ بِدءٍ لا غنى عنها لِتَكُونَ ناجحاً داخلَ النظام.
جليٌّ تماماً أنّ بحثَ العصرانيةِ الديمقراطيةِ عن الحقيقةِ في وجهِ النظامِ القائم، وموقفَها الأيديولوجيّ، وردودَها على الأسئلةِ الثلاثةِ الأولية؛ هو بمثابةِ نظامٍ بديل. فالبحثُ عن الهويةِ الاجتماعيةِ بجميعِ مناحيها، وتحليلُها، وعرضُ حلولِها؛ إنما هو صُلبُ الكفاحِ في سبيلِ الحقيقة. وقد بَسَطَت مرافعاتي مُحَصِّلةَ هذا البحثِ والكفاح، ولو بخطوطٍ عريضة. لذا، لا داعي للتكرار. الموقفُ الأيديولوجيُّ يُعَبِّرُ عن تَخَطّي الهيمنةِ الأيديولوجيةِ للحداثةِ السائدةِ بتوجيهِ الانتقاداتِ الشاملةِ لها. والدفاعُ عن الحقائقِ الاجتماعيةِ التي بحوزةِ اليدِ موقفٌ أيديولوجيّ. أما إظهارُ مدى افتقارِ الحداثةِ الرأسماليةِ إلى الحقيقة (تفضيل الفردية على المجتمع، شنّ الهجوم على الهوية الاجتماعية)، وعَكسُ حقيقةِ الأمةِ أو المجتمعِ الاقتصاديِّ والأيكولوجيِّ والديمقراطيّ، وعكسُ مدى قوةِ هذه الحقيقة؛ إنما هو معنيٌّ بهذا الموقف.
أولُ جوابٍ مشتركٍ سيُعطى على أسئلةِ: كيف نعيش؟ ما العمل؟ ومن أين البدء؟، يجب أنْ يَبتَدِئَ من داخلِ النظامِ وعلى أساسِ معاداةِ ومناهَضةِ النظام. لكنّ مناهَضةَ النظامِ من داخلِه، تقتضي الصراعَ من أجلِ الحقيقةِ في كلِّ لحظةٍ على المستوى الذي قام به الحُكَماءُ القُدامى، ولو كَلَّفَ ذلك الموت. إذ عليكَ بالردِّ بشكلٍ متداخلٍ على السؤالَين: كيف نعيش، ومن أين البدء؟، وعليك بالتخلي عن هذه الحياةِ والنفورِ منها وكأنكَ تَخلَعُ قميصَ الجنونِ والطيشِ الذي أَلبَسَتكَ إياه الحداثةُ كدرعٍ حصين. وعندما تَدعو الحاجة، فعليك بالقَيءِ في كلِّ لحظة، مُطَهِّراً مِعدَتَكَ ودماغَكَ وجسدَكَ من تلك الحياةِ المُعَشِّشةِ داخلك. عليك أنْ تتقيأَ ما في داخلِك رداً عليها، حتى لو عَرَضَت نفسَها عليكَ وكأنها مَلِكةُ جَمالِ العالَم. وبالتداخلِ مع السؤالَين السابقَين، فعليكَ بالردِّ على سؤالِ ما العمل، بأنْ تَكُونَ داخلَ ممارسةٍ عمليةٍ فعّالةٍ ومتواصلةٍ تجاه النظام. أي أنّ جوابَ ما العمل هو الممارسةُ العمليةُ الواعيةُ والمُنَظَّمة.
أما بالنسبةِ لنظامِ العصرانيةِ الديمقراطية، فالردُّ على الأسئلةِ الثلاثةِ يعني التلاحمَ الأيديولوجيَّ والعمليَّ مع عناصرِ هذا النظام. أي أنّ الدورَ الذي كان يُسَمّى سابقاً بالحزبِ الطليعيّ، يجب توطيده على شكلِ ريادةِ العصرانيةِ الديمقراطيةِ نظرياً وعملياً. أما المَهَمَّةُ الأوليةُ للريادةِ الجديدة، فهي تغطيةُ الاحتياجاتِ الذهنيةِ والإراديةِ للمجتمعِ الاقتصاديِّ والأيكولوجيِّ والديمقراطيّ، الذي يُشَكِّلُ الدعاماتِ الثلاثَ لهذا النظام (الإدارة الكونفدرالية الديمقراطية المدينية والمناطقية والإقليمية والوطنية والماوراء وطنية). ومن الضروريِّ بمكان تشييد البنى الأكاديميةِ بما يَكفي كَمّاً ونوعاً. هذا وبالمقدورِ إنشاء هذه الوحدات الأكاديميةِ الجديدةِ بأسماءٍ مختلفةٍ تتوافق ومضامينَها، بحيث لا تَقتَصِرُ فقط على انتقادِ العالَمِ الأكاديميِّ للحداثة، بل وتَصُوغُ البديلَ اللازمَ أيضاً إلى جانبِ ذلك. أي أنّ الواجبَ الحتميَّ هو إنشاءُ الأكاديمياتِ بشأنِ كافةِ ميادينِ المجتمعِ حسبَ الأهميةِ والحاجة، وفي مقدمتِها ميادين التقنية الاقتصادية، الزراعة الأيكولوجية، السياسة الديمقراطية، الدفاع – الأمن، المرأة – الحرية، الثقافة – الهوية، التاريخ – اللغة، العلم – الفلسفة، والدين – الفن. ذلك أنه محالٌ إنشاء عناصر العصرانيةِ الديمقراطية، دون وجودِ فريقٍ كادريٍّ أكاديميٍّ متين. أي، وكيفما لا معنى للكادرِ الأكاديميِّ من دونِ عناصرِ العصرانيةِ الديمقراطية، فعناصرُ العصرانيةِ الديمقراطيةِ أيضاً لن تُفيدَ أو تَنجَحَ في شيءٍ من دونِ الكوادرِ الأكاديميّة. بمعنى آخر، فالكُلّيّاتيةُ المتداخلةُ شرطٌ لا ملاذ منه في سبيلِ المعنى والنجاح.
يجب التخلي عن مفهومِ الحداثةِ الرأسماليةِ وتَخَطّيه بكلِّ تأكيد، والذي يَقِفُ كلباسِ اللعنةِ على المرء، ويَكُونُ فِكرُه شيئاً وقولُه شيئاً وعملُه شيئاً آخَر. فعَلاماتُ النُّبلِ والجَلالِ هي ضرورةُ عدمِ التمييزِ إطلاقاً بين الفكرِ – القول – العمل، والتحلي بالحقيقةِ دوماً، وعيشُها وارتداؤُها ضمن كُلّيّاتيةٍ متكاملة. وكلُّ مَن يَعجزُ عن تجسيدِ ثلاثتِها معاً فيما يخصُّ كيف نعيشُ وما العملُ ومن أين البدء، فعليه ألا يخوضَ حربَ الحقيقة. فحربُ الحقيقةِ لا تَقبَلُ تحريفاتِ الحداثةِ الرأسمالية، ولا تستطيعُ العيشَ بها. وباختزال، فالكادرُ الأكاديميُّ هو الدماغُ والتنظيمُ والأوعيةُ الشعرية المنتشرةُ في الجسم (المجتمع). الحقيقةُ متكاملة. الحقيقةُ هي الواقعُ الكُلّيّاتيُّ المُعَبَّرُ عنه. والكادرُ هو الحقيقةُ المُنَظَّمةُ والمُصَيَّرةُ ممارسةً.
على ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ أنْ تُدرِكَ أثناء تحديثِها لذاتِها أنّ السبيلَ إلى ذلك يَمُرُّ من ثورةِ الحقيقةِ التي هي ثورةٌ ذهنيةٌ وثورةُ نمطِ الحياة. إنها ثورةُ الخلاصِ من الهيمنةِ الأيديولوجيةِ للحداثةِ الرأسماليةِ ومن نمطِ حياتِها. هذا ويجب عدم المبالاةِ برجالاتِ الدينِ والشوفينيين العِرقيين الزائفين المتشبثين بالتقاليد. فهم لا يُحاربون الحداثةَ الرأسمالية، بل يطمَعون في حصةٍ زهيدةٍ كي يَكونوا حُرّاساً أوفياءَ لها. لذا، يستحيلُ التفكيرُ قطعياً في أنّ أمثالَ هؤلاء يكافحون في سبيلِ الحقيقة. علماً أنهم ليسوا مهزومين وحسب تجاه الحداثة، بل هم في وضعِ التَّمَلُّقِ والتَّماهي أيضاً. ولَئِنْ كانت الحركاتُ اليساريةُ والفامينيةُ والأيكولوجيةُ والثقافيةُ القديمةُ تطمحُ إلى مناهَضةِ الحداثةِ بمنوالٍ مبدئيّ، فهي مُلزَمةٌ بمعرفةِ كيفيةِ خوضِ حربِ الحقيقةِ ضمن كُلّيّاتيتِها، وإسقاطِها على أنماطِ حياتِها أيضاً.
تَحظى حربُ الحقيقةِ بالمعنى وتُحرِزُ النجاح، كلما دارَت رحاها في كافةِ مجالاتِ الحياة، وفي جميعِ الميادين الاجتماعية، في الوحداتِ والمُكَوِّناتِ الاقتصاديةِ والأيكولوجيةِ الكومونالية، والمدنِ الديمقراطية، والأماكنِ المناطقيةِ والإقليميةِ والوطنيةِ والماوراء وطنية. لا يُمكِنُ خوض حربِ الحقيقة، دون معرفةِ العيشِ كالرُّسُلِ والحواريين البارزين في مطلعِ فتراتِ ولادةِ الأديان، ودون الهَرَعِ وراء الحقيقة. وحتى لو تمَّ خوضُها دون ذلك، فنجاحُها مستحيل. إنّ الشرقَ الأوسطَ في مَسيسِ الحاجةِ إلى حِكمةِ الإلهاتِ المُستَحدَثات، وإلى أمثالِ زرادشت وموسى وعيسى ومحمد، سانت باول (بولص الرسول)، ماني، وَيس القَرَني ، منصور الحلاّج، السهروردي، يونس أَمره ، وبرونو. ذلك أنّه من غيرِ الممكنِ إنجاح ثورةِ الحقيقة، دون التحلي بإرثِ القدامى الأوائلِ المُستَحدَث، الذي لَم يأكلْ عليه الدهرُ أو يَشرب. فالثوراتُ والثوريون لا يَموتون، إنما يُثبِتون إمكانيةَ الحياةِ – فقط وفقط – بتَبَنّي ميراثِ هؤلاء. وثورةُ الشرقِ الأوسطِ هي ثورةُ توحيدِ الفكرِ والقولِ والعمل. وهي جدُّ غنيةٍ من هذه الناحية. والعصرانيةُ الديمقراطيةُ ستُقَدِّمُ مساهماتِها وتؤدي دورَها التاريخيّ، بإضافةِ انتقاداتِها بشأنِ المدنيةِ والحداثةِ الرأسماليةِ إلى هذه الثقافة.
ينبغي على فردِ الحضارةِ الديمقراطيةِ أنْ يَحيا ضمن تكامُلِ ووحدةِ كفاحِ الفكرِ – القول – العملِ الدؤوبِ إزاءَ فُرسانِ المَحشرِ الثلاثِ للحداثةِ الرأسمالية (الرأسمالية، الصناعوية، والدولتية القومية). وبالمِثل، عليه خوض كفاحِ حياةِ الفكرِ – القول – العملِ المتواصلِ مع مَلائكةِ الخلاصِ للعصرانيةِ الديمقراطية (المجتمع الاقتصاديّ، المجتمع الأيكولوجيّ، المجتمع الديمقراطيّ). وما لَم يَفعلْ ذلك، فلا يُمكِنُه تحقيق كينونتِه أو إنشاء ذاتِه كقائدٍ للحقيقة. كما لَن يَكُونَ القائدَ (المُرشِدَ) المُنجِزَ للعدالةِ والحريةِ وعالَمِ الديمقراطية، ما لَم يُواظِبْ على وحدةِ وتكامُلِ الكفاحِ والحياةِ داخلَ مُكَوِّناتِ الكوموناتِ الاجتماعيةِ ومُكَوِّناتِ الأكاديمياتِ بالقدرِ عينِه. انتقاداتُ الكتبِ المقدسةِ والإلهاتِ الحكيماتِ قَيّمة، في حالِ توجيهِها رداً على تَحَوُّلِها إلى أداةٍ بِيَدِ المدنيةِ والحداثةِ المهيمنتَين. وما يتبقى منها، إنما هو ميراثُ حياتِنا الذي لَم يتقادم، وهويتُنا الاجتماعية. ومُناضِلُ الحقيقةِ في العصرِ الديمقراطيّ، هو ذاك الذي يَنقشُ هذه الهويةَ في شخصيتِه، ويَحيا إرثَ الحياةِ ذاك ويُحييه بِحُرّية.